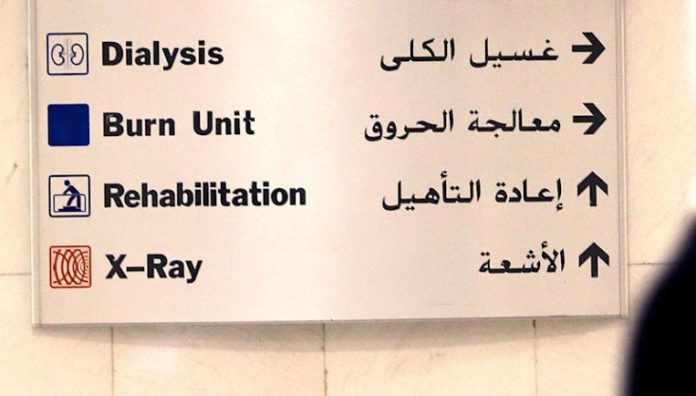منذ نحو ربع قرن، تزخر البيانات الوزارية للحكومات بالعناوين والأهداف الثورية في ما يتعلق بالقطاع الصحي، غير أن ذلك لا يعدو كونه تفكيراً بصوت عالٍ، ويبقى حبراً على ورق، من دون أن ينعكس على أرض الواقع، كما خلصت دراسة لمركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت
طوال 22 عاماً، لم تنتج 13 حكومة سوى ثلاثة قوانين تطابقت في أهدافها مع ما نصّت عليه بياناتها الوزارية، ولكن من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. الوكالة الوطنية للدواء ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية (قانون ضمان الشيخوخة الذي أقر بعد عشرين عاماً من العمل عليه) وسلامة الغذاء هي القوانين «الثورية» الثلاثة التي توقّف مسارها عند صدورها في الجريدة الرسمية، بعدما تعطّلت معظم مراسيمها التنفيذية لأسباب تتعلّق بجانبين أساسيين: أولهما الأهداف الطموحة التي لا تتناسب مع الواقع ولا مع النهج المتبع في الموازنات التي يذهب جلّها إلى الإنفاق على الاستشفاء الخاص، وثانيهما العقدة المتعلقة بالمحاصصة والطائفية التي تقف حائلاً دون التطبيق. سببان يقودان إلى خلاصة واضحة تظهر أن «معظم ما تتضمنه البيانات الوزارية يبقى كلاماً، ومعظم القوانين التي تقرّ نقرّها فقط لأننا نريد ذلك من دون أن تكون قابلة للتطبيق، بسبب بنودها الفضفاضة التي يصعب على الحكومات ترجمتها لشيء»، وفقاً للدكتور فادي الجردلي، رئيس مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت، وأحد معدّي دراسة أصدرها المركز حلّلت البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة والأهداف الواردة في السياسات الصحية العامة والموازنات بين عامَي 2000 و2022.
بين النص والواقع
طوال هذه المدة، بدا الانفصام واضحاً بين البيانات المكتوبة وواقع القطاع، ولم تنعكس الأهداف الصحية في الموازنات المرصودة لوزارة الصحة، باستثناء بند واحد فقط خصّصت له اعتمادات ضمن موازنة وزارة الصحة، وهو بند الرعاية الوقائية الذي بُدئ تنفيذه الأخيرة منذ عام 2014، ويشمل «الكشف المبكر عن الأمراض والتطعيم وقطاع مراكز الرعاية الصحية الأولية». مع ذلك، لا يمكن المقارنة بين المبلغ المرصود للرعاية الأولية والوقائية والذي لا يتجاوز 10% من الموازنة، وما تدفعه الوزارة على الاستشفاء في القطاع الخاص والذي فاق عام 2022 الـ74.9%، على عكس ما يجري في معظم دول العالم، حيث تتخطى المبالغ المرصودة للرعاية الوقائية بين 30% و40% من الموازنة.
ورغم أهمية البيانات الوزارية كونها تشكّل خريطة عمل للمدة التي تحكم فيها الحكومة، وتتضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل على تحقيقها في مختلف القطاعات، على أن تترجم في الموازنات العامة العائدة لكل إدارة معنية، إلا أن أقل ما يمكن أن يُقال عن بيانات الحكومات اللبنانية المتعاقبة أنها بلا جدوى طالما أنها لا ترتبط بالموازنات.
ويشير تحليل أرقام موازنة وزارة الصحة إلى أن معظم الإنفاق يذهب إلى الاستشفاء الخاص، رغم أن الهدف الذي يتكرر في معظم البيانات الوزارية هو الاستثمار في القطاع الاستشفائي الحكومي وتعزيز فرص نهوضه.
لا بل أكثر من ذلك، جرى رفع اعتمادات الاستشفاء في القطاع الخاص بمعدل الضعفين تقريباً خلال عشرين عاماً، من 205 مليارات ليرة عام 2000 إلى 475 مليار ليرة عام 2020، في مقابل صرف 36% فقط على الاستشفاء في القطاع الحكومي في عزّ رفاهية هذا الصرف.
وبقيت الدولة مرهونة للقطاع الخاص بسبب تراكم الديون في ذمتها له، والأسوأ من كل هذا أنه لم يتمّ تخفيض تلك الديون منذ بدايتها عام 2000 وحتى الآن بسبب عدم لحظ اعتمادات لوزارة الصحة لسدادها!
والأزمة هنا ليست فقط في هدر الأموال، وإنما تكمن في «أننا لم نحصل على صحة أفضل ولا خففنا نسبة الدخول إلى المستشفيات»، يتابع الجردلي، مشيراً من جهة أخرى إلى تراجع في جودة ونوعية الخدمات رغم «الغرف» من الموازنات. وهنا بيت القصيد: إغفال شق الرعاية الوقائية التي حظيت في آخر موازنة لوزارة الصحة بنسبة 16%، رغم التهليل الذي رافق الموازنة باعتبارها، رابع أكبر الموازنات العام الماضي.
وتجنح الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية نحو عناوين فضفاضة، ويبدو ذلك جلياً في الأهداف والعناوين والوعود والمواضيع المكررة في البيانات، إلى درجة أنه «جرت إعادة هذه البرامج وهذه الأهداف في البرامج الانتخابية التي وضعتها الكتل والأحزاب المختلفة التي شاركت في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022، كالتغطية الصحية الشاملة وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…».
ومنذ عام 2014، يجري نقل تلك العناوين بطريقة «القص واللصق»، وهناك عناوين تكررت 13 مرة، بعدد البيانات الوزارية، مثل «تعزيز قطاع الاستشفاء العام» و«إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» و«خفض تكلفة الاستشفاء على المواطنين» و«إنشاء شبكات الحماية الاجتماعية». والأمر نفسه ينطبق على السياسات الصحية التي تصدر على شكل قوانين وقرارات تتخذ في مجلس الوزراء وقرارات وزارية وتعاميم صادرة عن الوزارة، والتي تصرف عليها آلاف الدولارات، ولا يتحقق الغالب الأعم منها.
وهذا يعني أنه «لا ينبغي أن نفرح بزيادة موازنة وزارة الصحة لأن ذلك لا يعني بالضرورة أنها حسبة جيدة»، يقول الجردلي، طالما أن «الخطأ الإستراتيجي» يتكرر من بيان إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى، وإلا ما معنى أن تكون موازنة وزارة الصحة رابع أكبر موازنة، فيما الوقاية الصحية غير متوافرة؟
وإلى ذلك، ثمة ما هو أسوأ، ويتمثل بالضبابية في صرف الأموال. إذ بيّنت الدراسة «غياب الشفافية في صرف الأموال، خصوصاً خلال الأزمة المالية الأخيرة وأزمة كوفيد ــــ 19، ولم تتبيّن قيمة المبالغ التي أنفقتها وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالاستجابة لهاتين الأزمتين».
قوانين لا تُطبق وإنفاق مفتوح على الاستشفاء الخاص
قسّم معدّو الدراسة فترة الـ22 عاماً، بين عامَي 2000 و2022، إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى حملت شعار تعزيز الرعاية الوقائية والمستشفيات العامة وتحسين جودة الخدمات، ورافقت 6 حكومات من 2000 إلى 2009، والثانية بعنوان إصلاح القطاع الصحي وتعزيز مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية، ورافقت 7 حكومات من 2009 إلى 2022. وقد جرى الاعتماد في التحليل على ثلاثة مستويات، انطلق فيها معدو الدراسة من التحليل الموضوعي للبيانات إلى الربط بين السياسات والأهداف الصحية، وأخيراً إلى ربط الموازنات بالبيانات الوزارية.
2000 – 2009: أهداف فضفاضة
قسّمت هذه المرحلة إلى فترتين، الأولى بين عامَي 2000 و2005، وجرى خلالها التركيز على 3 أهداف أساسية ستكون بمثابة لازمة ستتكرر في كل البيانات اللاحقة، وهي «تنظيم وتفعيل قطاع الاستشفاء العام وتحسين تغطية الرعاية الصحية للوصول إلى جميع المواطنين عبر إصلاح الصناديق المختلفة، وتخفيض كلفة العلاج في المستشفيات». وشهدت هذه الفترة صدور قانونين و11 مرسوماً و5 قرارات وزارية و7 تعميمات. ورغم أن 23 من أصل 25 إصداراً تطابقت مع الأهداف الموضوعة، إلا أنه تعذر تطبيق معظمها لأنها «كانت غير محددة وغير قابلة للقياس». أضف إلى ذلك أن باب الإنفاق بقي مفتوحاً على الاستشفاء الخاص، وبلغ في هذه المدة 74.7%.
أما في الفترة الثانية (2005 – 2009)، ورغم احتلال موضوع الصحة العامة فقرة أطول في البيانات الوزارية، إلا أن معظم ما ذكر من عناوين كان تكراراً لأهدافٍ ملحوظة في البيانات السابقة، كتحسين جودة الخدمات وتعزيز الرعاية الوقائية وإصدار بطاقات الأدوية والاستشفاء (إطلاق البطاقة الصحية للأمراض المزمنة مثالاً) واستكمال ورشة الإصلاح في صندوق الضمان… وفي هذه المدة، صدر فقط قانون واحد لم يتطابق مع الأهداف الموضوعة في البيانات الوزارية ومرسوم واحد و3 قرارات وزارية تحت عنوان تحسين جودة الرعاية (القرار 571 الذي نص على شروط تسجيل الأدوية والخدمات الصحية (…) والقراران 301 و306 المتعلقان بخفض تكلفة الرعاية عبر خفض تكلفة الأدوية الصيدلانية). ورعم نجاح الوزارة في حينها في خفض السعر العام لـ360 دواء بين عامَي 2001 و2006 وتوفير حوالى 10 ملايين دولار، إلا أن ذلك لم ينعكس انخفاضاً في رسوم العلاج في المستشفيات، بل على العكس ارتفعت نسبتها من 67% عام 2005 إلى 69.4% عام 2009.
2009 – 2022: لا أهداف جديدة
قسّمت الدراسة هذه المدة إلى 5 مراحل، يمكن اختصارها باثنتين:
الأولى بين عامَي 2009 و2014 جرى التركيز فيها على توفير اعتمادات لدفع ديون المستشفيات المتراكمة من عام 2000 وحتى عام 2004 مع استعادة جزء كبير من الأهداف السابقة، ولكن من دون أن تُلحظ له اعتمادات في الموازنة، مع عناوين فضفاضة وبلا وجهة محددة، كـ«الالتزام بخطة الإصلاح الصحي والبطاقة الصحية والتغطية الصحية لغير المؤمّنين ومؤازرة المستشفيات الحكومية».
أما المرحلة الثانية (2014 – 2020) فكانت بلا أهداف جديدة، وما صدر من قوانين وتعاميم كان استجابة لأهداف صحية سابقة، منها ما يتعلق بسلامة الغذاء (قرار وزاري لمعالجة مياه الشرب وتكريرها) وزيادة التغطية الصحية لمن تجاوزوا الـ64 من العمر (التعميم 109 مثالاً)… فيما الجديد الوحيد فيها هو تعزيز صناعة الأدوية والعقاقير التي لم تنجح بعد هذه السنوات في خفض الفاتورة الدوائية ولا في تعزيز سوق الدواء كما كان مؤمّلاً، بقدر ما فتحت الباب على مصراعيه على الترخيص لمصانع محلية بالعشرات.
وفي خاتمة المراحل، كانت مرحلة الأزمة التي انطلقت منذ عام 2020 وحتى اليوم، وهي المرحلة التي اختصرت فيها البيانات الوزارية بمعالجة تبعات أزمة سعر الصرف وأزمة كورونا.